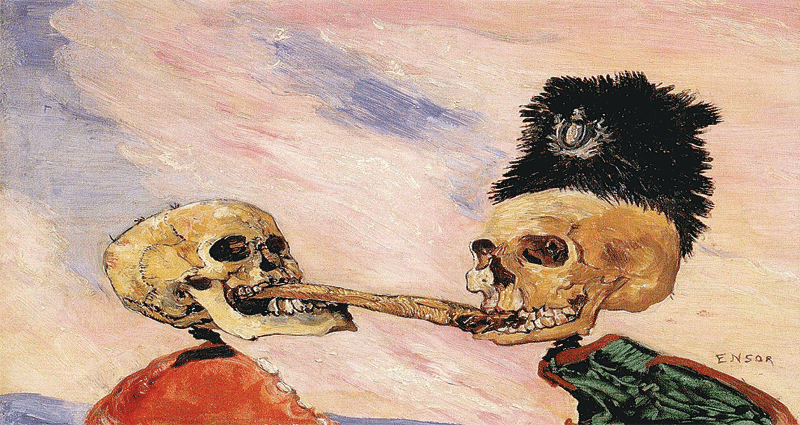
مطر وأيديولوجيا
صالح العامري -
1- ما هو المطر؟
هناك ثمة مطر ما، مطر آخر، مطر يفضح الطفولة ويشردها، مطر يجعلني أضحك على فكرة الفرق بين الداخل والخارج، بين البنيان والعراء، بين العواء في البراري والانصياع لفكرة الجدران الستة. ذلك أنّ الأشياء، أيما كانت، هي لا شيء أبداً إن لم تكن تمسّ أو قد مسّت طفولاتنا، وإن لم تكن تتمكّن أو قد تمكّنتْ من أعوادنا وأصلابنا، وإن لم تكن تجرفنا الآن أو قد جرفتنا فعلاً في مهبّها العاصف وهبوبها الشقيّ.
ما إن أحس برائحة المطر، حتى يدهمني ليلٌ أسمر نبيل، ليلٌ تطقطق مواهبه وهداياه، مطر متشظٍّ كلؤلؤة تملأ الكون بهيئة نهرية أو فصل مغمور بالعشب والألق. شيء يخترقني، يدعوني للركض سراعاً إلى أقرب كرمة أو نخلة كي أسجد تحت أديمها أو إلى بقعة ضوء ساطعة كي يتنزل سائلها البارد الأصفر في حلقي.
لقد كان للطفولة، على أكثر تقدير، سطوتها المخبِّلة على قصة المطر، إذ لم يكن بمقدور البيت السعفيّ في ستينيات القرن المنصرم وأوائل السبعينات إلا أن يرضخ لرغاء الزائر المائيّ ودمدمته الغزيرة. لقد كانت الأكواخ السعفيّة، والذي هي من نتاج الطبيعة وأخلاقها الدمثة، تصلّي هي الأخرى، تماماً كما هو المطر، بأغنية متقافزة من جوف الغيب، وبنشيد حراق يليق بالغرباء والمسافرين والعابرين، الذين هم نحن، أبناء الحياة.
كان المطر يعجن نفسه في جوف ناي السعف وجذوع النخيل، فتخرج من ذلك الفرن البارد أرغفة الموسم الحارّة، وينبعث ذلك الهواء المتكثف من أفواهنا، ليس على جدران أو مرايا المدن، بل منقذفاً إلى الهواء نفسه، دون حاجز أو مصدة بائسة.
لا فرق بين البيت والمطر، بين أن يسيل على أجسادنا الصغيرة أو على سقوف العرشان المستسلمة لأنامله التي تعزف على البيانو القديم، البيانو الذي تعرفه القرية في سرها وظلالها، وليس في قرنها الحديث أو في عصرها المتقدم.
لقد كنا أعواناً للمطر وحواريين له، لهذا عندما يتنزل على رؤوسنا وأصابعنا وأطرافنا، لا نلجأ إلى الهرب، ولا نذعر من جمره البارد، بل نلبسه كمعطف شتويّ، أو نرقص وسط ألعابه النارية كما لو أننا نخلق من جديد تحت حكايته الأولى، التي هي أقدم من أية حكاية أخرى.
يا الله، كيف يمكن أن يكون هناك مطر بهذه الطريقة؟ مطر حنون حتى وهو يهزنا بعنف ويعصف بالحجر والمدر والسعف، مطر ذو رؤوس إبرية مدببة، ومع ذلك نتفتح شجيرات أسل في طريقه، كأن أحدنا يحضن الآخر ويعانقه، وكأنّ الأحضان لا بد لها من قسوة حتى نفقه معناها أو معنى الحبّ.
يا الله، لقد كنا عراة في لمسة المطر الفضيّ، المطر الأغبر، المطر اللذيذ، وكنا مستعدين دوماً لأن يجرفنا إلى أي نهر أو بحر، دون أن نكون مرتابين في نواياه أو قسوته. لقد كان شيئاً في داخلنا الصلب، مع أنّه كانه يبدو للبعض بأنه يسيل وينسكب من ميزابه ومزرابه العلويّ خارجنا. لقد كان دفقاً عنيفاً في لهبنا وشمعتنا، وليس وحشاً علينا أن نقفل عليه أنفسنا وأطفالنا وراء الأبواب الفولاذية والجدران المنيعة.
2- رقاعة الأيديولوجيا
ليت للأيديولوجيا، «أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل»، حتّى تنسرب تلك الأيديولوجيا حصاناً سبّاحاً في الهواء، بظهر أملس، له خفة فخذي الظبي، يقفز ثعلباً، ويعدو ذئباً. ليت للأيديولوجيا عزة نفس كرّارة فرّارة، متناغمة مع جرح الإنسان ومع ضعفه وهشاشته، مع فرحه الناقص وحزنه الأزليّ. لكنّ واقع الحال، أنّ الأيديولوجيات هي طبول فارغة تصفر فيها الريح وتمتح من معادن الثعالب البلاستيكية، هي نسيج ملعون من قيء وسعال وأوبئة، من رطانات متذائبة، من تعميمات جوفاء. هي انهيار اللسان في اللسان، واندلاق القويّ على الضعيف، وانجراف البشاعة على اللطافة، وزواج السياسة الخبيثة بالاقتصاد البشع، وانحسار الجزر الذي يبرز عري الشطآن وبراءتها إلى مدٍّ يسترها ويُمَنّيها بالاستطالة الدائمة.
كل أيديولوجيا- في هذا العالم الضيّق الأفق والمترامي الأطراف- مهما بلغت ضآلة حجمها وبؤس مذهبها، صار لديها بطاقة خضراء وكلمة مرور، للمساهمة في الخراب والتفسخ، في اللعنة التي تنفض أمراضها وأوبئتها على رؤوس الملأ، حتّى صارت مهمتها المقدسة أن تنثر بذورها المسمّمة وأن تتطاول أعناقها على جهات وزوايا الأرض الحزينة التي ضاقت ذرعاً بمخلوقاتها البلهاء.
لا أريد من يقول أن كل فكرة هي أيديولوجيا، بل من يزرع جذراً قوياً من الجذور السمراء في الأرض القاحلة، ومن يسكن عميقاً في تلك الرحلة الأشبه بغمضة عين أو خيبة أمل، ومن ينشد في الليل المدلهم الطويل بقلبه الذي يخفق بالمطر الذي هو بيت وثير، وبالطيش الذي هو الحب، وبالتمرد الذي هو السلام، وبالجنون الذي هو قلب العقل.
